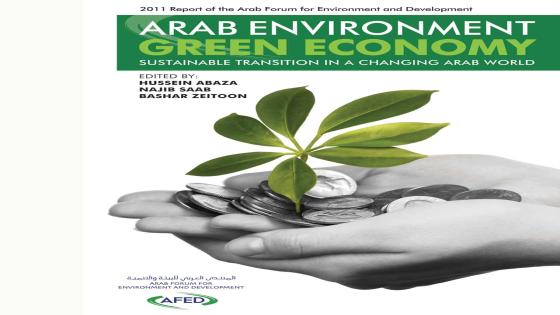قراءة نقدية للدكتور مبارك ربيع
آفاق بيئية : محمد التفراوتي
السرد الروائي و الوعي الزماني في رواية ” وزير غرناطة”
“لا بد لمن يتحدث عن ” وزير غرناطة ” أن يستحضر ظروف ظهور هذا العمل الأدبي ، و هو يأتي باكراً في تاريخ الأدب المغربي الحديث ، و في جنس منه لم يكن معروفاً ، أو بالأحرى لم يكن الإنتاج فيه قد بلغ مرحلة الاعتبار و النضج “.
و لا بد كذلك لمن كان من جيلي أو على قرب منه ، أن يعتبر تجربته في بداية الاحتكاك المعرفي بالآثار الأدبية الحديثة ، أن تغمره ذكرى التجربة بكامل غشيتها وإبهار نورها ، و هو يكتشف بين رفوف ما يقلبه من محتويات مكتبات ” الحبوس” في فترة الخمسينيات من القرن الماضي ، ليصادف اسم المؤلف عبد الهادي بوطالب على مؤلفه ” وزير غرناطة ” ؛ إنه انبهار الكشف و الاكتشاف لوردة أطلسية أصيلة بين جنان و أغراس وارفة ، من أعلام كلها مشرقي : ففي تلك الفترة من مراحل الفكر المغربي ، و من تاريخ هذا الوطن العزيز ، و هو الحسير الأسير إذ ذاك ؛ كان يبدو للناشئة و كأن أبواب الأجناس الحديثة في الأدب العربي ، إنما هي حكر بالطبيعة على أفذاذ الثقافة و الأدب العربي في ذلك الحين ، من أمثال الزيات والرافعي و طه والعقاد و تيمور و أضرابهم ؛ كما هو الأمر في الشعر العربي الحديث ، لشوقي وحافظ إبراهيم و البارودي و غيرهم ؛ أما العثور على يراع مغربي في هذه الساحة الشاسعة الملأى و الحبلى بكل ما هو مشرقي ، علاوة ما هو أجنبي مترجم بأقلام مشرقية كذلك ؛ فكان بالفعل كشفاً و اكتشافاً ، يولد كل الدهشة والانبهار ، لا يكاد يضاهيه إلا أن تصادف في ظروف مماثلة ، و بالمشاعر نفسها ، علماً مماثلا هو عبد المجيد بنجلون في مجموعته القصصية الأولى المعنونة بـ – وادي الدماء – ” .
بهذا الاستهلال استهل الدكتور مبارك ربيع مداخلته أو بالاحرى استعرض بحثه امام نخبة جمة من المفكرين والادباء والسياسين وأدباء وكذا الدبلوماسيين من داخل المغرب وخارجه ، وضمن ما يقارب 12 مداخلة على مدى يوم كامل.
امتطوا تباعا صهوة “التباري” لتناول شخصية صاحب رواية “وزير غرناطة ” ،الصادرة في خمسينيات القرن الماضي ،الدكتور عبدالهادي بوطالب، من مختلف الزوايا والمناحي، وكانه سوق عكاظ.. جعلت الرجل المحتفى به ،مستشار جلالة الملك المغفور له الحسن الثاني، في الندوة تكريمية بمركز الحسن الثاني للملتقيات الدولية بأصيلة يعقب بخجل وتواضع بقوله :
“لم يسبق لي أن وجهت نفسي للمرآة لمعرفة نفسي ..لكن الآن رأيت نفسي في مرآتكم..لقد منحتموني دفعة دافقة تشجعني للاستمرار..”
“أنا أعفيكم من تكريمي بعد مماتي فاحسن تكريم لأي شخص يجب أن يكون في حياته وليس في مماته”
أعرب الروائي والقاص المغربي “صاحب “رفقة السلاح والقمر ” الدكتور مبارك ربيع كون اسم المؤلف عبد الهادي بوطالب كان وارداً في سجل الحركة الوطنية ، و من أعلامها المقدمين ، كما كان مقروءاً على صفحات الجرائد ، و لا سيما منها ” الرأي العام ” ذات التوجه الديموقراطي المعروف إذا ذاك ، عن حزب الشورى والاستقلال وزعيمه المرحوم محمد بلحسن الوزاني ؛ و لم تكن ” الرأي العام ” في مكانتها لدى المواطن المغربي في ذلك الحين ، و في درجة الإقبال على تتبعها من قبل فئات الشعب ، تقل عن نظيرتها ” العلم ” الناطقة باسم أكبر حزب وطني و هو ” حزب الاستقلال ” ؛ كل هذا كان معروفاً ، و يحتل اسم عبد الهادي بوطالب فيه المكانة المرموقة ؛ لكن الحضور الثقافي في كتاب إبداعي أدبي ، في فن جديد على الفكر المغربي ،على نحو يضاهي أعلام المشرق العربي إذ ذاك ، كان له طعم خاص ودرجة متميزة ، ربما كانت كفيلة أن تذهب بنا إلى التردد و التريث في الحكم قبل الاقتناع و اليقين ، لولا أن الاسم واضح النبرة و النغمة و النسبة : إنه عبد الهادي بوطالب و كفى .
كما أن حالة التهيب الفكري، يضيف الدكتور مبارك، التي كان من الضروري أن يعاني منها جيل قراء الخمسينات ، في أوج تطلعاته و دوافع استطلاعه ، لتلتقي على نحو ما بإطروحة قد تبدو هامشية ، تعرض في تقديم الكتاب ، من خلال مقالة محمد سعيد العريان الواردة بتاريخها وهو شهر يبراير 1950 ؛ و قد أحسن المؤلف صنعاً بالحفاظ على هذه المقدمة في صيغتها و مكانها ، فأصبحت بذلك عنصراً هاماً في التاريخ الأدبي وفي النظرة المخالفة أو الأخرى على الأصح ، لسيرورة لأدب المغربي ، بغض النظر عن موقف المؤلف أو غيره من ذلك ، و بعيداً عن مفهوم الخطإ و الصواب في هذا الشأن .
فكرة هامشية حقاً ، لكنها تفرض نفسها بقوة ، و يمكن أن تعتبر مدخلا لنقاش واسع عريض ،يقول الدكتور ربيع ، يكتفي بالإشارة إلى بعض معالمها ، و هو المتمثل في التصريح القوي الواضح ، من الأديب و العالم المدقق في التراث الأندلسي ، محمد سعيد العريان ، وهو محقق ” العقد الفريد ” و الكاتب الروائي صاحب روايات اجتماعية و تاريخية على الخصوص من بينها و أشهرها : ” على باب زويلة “، و ” قطر الندى” ، و”شجرة الدر” ؛ و ذلك في تأكيده على أن الظروف الثقافية بالمشرق العربي ، أو رحلة المشرق ، هي مما جعل عبد الهادي بوطالب يتجه إلى تأليف هذه الرواية ، وهو في ذلك ،حسب العريان ، مثل غيره من المغاربة ، أمثال ابن خلدون والمقري لا تأتيهم حافزية التأليف إلا عند الاحتكاك المباشر بالثقافة المشرقية ، بل إن انحسار ذكر لسان الدين بن الخطيب و قصور صيته الأدبي رغم نوعية إنتاجه وتأليفه إنما هي ثمرة انعدام رحليته إلى المشرق (1).
وأكد ، الدكتور مبارك والذي يعتبر أحد الأسماء المؤسسة للكتابة الروائية والقصصية بالمغرب ،أنه لا يريد أن يدخل في نقاش هذه الأطروحة ، و هي التي تبدو قابلة و لو جزئياً ، لتصدق على مرحلة فكرية و تاريخية مغربية مشرقية ، تمثل معالمها الهامة في أن المغاربة تميزوا – كغيرهم في بعض الوجوه – من ديار الإسلام الواقعة على أطراف ” العُجمة ” ، بالتركيز بدرجات مختلفة في مجالات المعرفة و أبوابها ، على ما يعتبر في العلوم بـ ” الوسائل” و ” الغايات ” و المتمثلة بالأساس في علوم اللغة والدين ، مع ما يبدو متكاملا معه من جنوح إلى الفكر الاجتماعي و السياسي ، دون الأدبي الإبداعي ؛ بل يبدو فيما عدا ذلك ، أن سمة الشفوية و الحفظ و الاسترجاع ، ظلت الطابع المهيمن على الثقافة المغربية .
و يصعب القول فيما عدا معالم الصورة المرسومة على هذا النحو ، إن الفكر والثقافة المغربية في العصر الحديث ، و منذ منتصف القرت العشرين ، كانت محكومة بقدر التبعية للثقافة المشرقية ، حتى و لو حصل ذلك في بعض المظاهر لأسباب موضوعية، بمعنى أن من غير الممكن استصدار مقولة مؤداها أن الثقافة و الفكر المغربي ، لم تكن لتأخذ طابعها التجديدي بدون الثقافة المشرقية ، إذ لا ينسى في هذا الباب أن الرافد الأوربي كان على الأبواب ، بشروطه الموضوعية و الأقوى ؛ و لعل ما سمح بالالتفات إلى الثقافة المشرقية بكل القوة المشهودة ، مع ضغط الرافد الأوربي الاستعماري ، يعود إلى دواعي هوية أكثر منه إلى أسباب أخرى ، أو مع تلك الأسباب الأخرى ، أمام تهديد جدي شامل للوطن و الإنسان في هويته و كافة مكوناته ؛ أو هكذا تبدى الأمر و استـًـشعر في حينه ، بطبيعة المرحلة و الحال و هذا ماتعبر عنه وثائق المرحلة و توجهات المرحلة الوطنية و مواقف رجالاتها في تاريخ المغرب في القرن العشرين على الأقل ؛ بل إن لب المواجهة بين الحركة الوطنية في سعيها للتحرر التحرير من جهة ، و المهيمن الاستعمار من جهة ثانية ، قد تركزت في هذا التوجه بالذات ، إذ ” و بما أن الاستعمار الفرنسي يعمل بكل قواه لاعتبار مراكش [ المغرب ] جزءاً من المنطقة الأوروبية ، و يبذل كل الجهد لفصلها عن البلاد العربية ، فكل عمل من شأنه أن يقوي الروح العربية في بلادنا و يجعل رابطتها قوية متينة ، لا يمكن أن يحظى بغير المقاومة و المعارضة المستمرة ” (2) ؛ ولعل مما يؤكد ذلك ، هذا الطابع المبالغ في بعض مظاهره حالياً في المغرب ، و المتمثل في الإقبال الأقوى على الثقافة الغربية بكافة أنواعها و ألسنها، بعد أن تطور تصور الهوية ومطلبها ، بغض النظر عن أبعاد مختلفة لهذه الظاهرة .
وساق الدكتور ربيع بعض معالم الظروف الثقافية الهامة و الأدبية المرافقة لظهور ” وزير غرناطة ” ، و في طليعتها التأليف الروائي في المشرق بالذات ، و في الجانب التاريخي منه على الخصوص ، متمثلا في جرجي زيدان من خلال رواياته العديدة عبر ” سلسلة تاريخ الإسلام ” وغيرها من رواياته التاريخية ؛ و كما لدى محمد سعيد العريان المشار إليه سابقاً ؛ وعلي الجارم في رواياته حول شخصيات أدبية تاريخية من قبيل : ” شاعر ملك ” عن المعتمد بن عباد ؛ و ” فارس بني حمدان ” عن أبي فراس ، و ” هاتف من الأندلس ” عن ابن زيدون ، و ” مرح الوليد ” ، و غيرها ؛ إلى نجيب محفوظ في رواياته التاريخية الأولى المعروفة ؛ فهذا المناخ العام للثقافة العربية و مظاهر أدبها الحديث ، قد تمثل في تناغم مع طموح ثقافي واجتماعي سياسي عام ، باتجاه استرجاع ذات مفتقدة ، أو مستشعرة على أنها كذلك ، مع وعي بضرورة تحمل المسؤولية ، للارتقاء إلى ما يعيد و يصنع وهج الماضي والمستقبل على السواء .
وبسترسل الدكتور ربيع محللا مفهوم ” السرد الروائي و الوعي الزمني ” الذي اقترحه مدخلا ، و هو يرمي تعميق النظرة إلى هذا العمل من خلال رصد قد يلتقي بشرط الذات المبدعة ، كما بشروط وجودها المحيطة في نطاقها العام والخاص ، قد يساهم بالإضافة إلى ذلك ، في تشكيل صورة الجواب بعض ما قد يرتبط بهذ الموضوع ، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة .
“و الواقع أن عنصري هذا المدخل و إن كان يبدو أنهما منفصلين فهما مترابطان متداخلان و متكاملان ؛فالسرد الروائي ، يقصد به نمط الحكي الذي يجعل العمل الأدبي مندرجاً ضمن جنس الرواية ( أو فنها ) ، و يخرج به و بالرواية بالتالي ، عن أي نوع أخر من السرد ، كنمط السرد التاريخي على سبيل المثال ، باعتباره نموذج السرد الأقرب إلى ذلك ، علماً بّأن المؤلف نفسه ، يؤكد بأن كل ما يأتي به من أحداث هي تاريخية محض ، علاوة على أنه من حيث الشكل ، لا يحمّل غلاف الكتاب ذلك المميز المعهود ، المتمثل في إضافة عبارة ” رواية ” إلى العنوان .
و يقصد بالوعي الزمني ، القصدية الفكرية المتمثلة في إدراك الدلالة الحدثية في صيرورة الزمن أي في التحول ، أو بالأحرى التعبير عن ذلك ، بما يجعل الزمن والفكر حضوراً و وجوداً واحداً ، سواء على اختلاف الأبعاد و المستويات في وهم أو حقيقة تفاوتها و دلالاتها ( مضى ، يمضي ، يأتي ) ، أو بما تتضمنه سعتها وامتدادها المتصل الأصيل من وحدة وجودية .”
ويضيف الدكتور ربيع انه عندما يأتي هذا التعبير على منحى السرد الروائي ، فإن الزمنية هي واصل الصلة الوثيق في تداخل و تكامل هذا الوعي مع سرده الروائي ، باعنبار ” أن أعظم توافق بين الفكرة و الواقع لهُو الزمن ، و [ لهُو] جريان الزمن بوصفه ديمومة . (3)
و من الواضح أن المؤلف نفسه يعمل على تعميق بعض المشاكل ، أو أنه يفرض جديتها ، بتأكيده على أنه لم يكتب إلا الحقائق أو الوقائع التاريخية ، مما يجعل الذهن ينصرف إلى تأويل القصد من ذلك ، و هو انصراف منهجي أكثر منه أي شئ آخر ، بالنظر إلى من يعرف شخصية الأستاذ عبد الهادي بوطالب في تفتحها المبكر ، و قوة نبوغها المشهودة في كافة مراحل حياته و مظاهر نشاطه ّ فماذا يكون القصد من ذلك التأكيد ؟ أهو التبرئة من الكذب على التاريخ ، نظراً للامعقولية ما تعرض به تلك الأحداث نفسها ؟ أم تبرئة الذات من ” لوثة ” الرواية التي مهما تبلغ أصالتها كجنس أدبي ، فهي إلى ذلك الحين يمكن أن تبدو في نظر البعض ، و كأنها غير جديرة بأن تكون مركزية في الاهتمام ، من حيث الجدارة الفكرية العلمية ، و بخاصة في مرحلة مجتمع في الحال التي كان عليها المغرب ، وفي مستوى المسؤولية و المكانة العلمية والسياسية والوطنية للأستاذ عبد الهادي بوطالب ؛ و إننا بهذا الخصوص لنستحضر مثال محمد حسين هيكل في روايته التي تعتبر الثمرة الأساسية أو البذرة الأولى للرواية في الأدب العربي الحديث ، و هي رواية ” زينب ” ( 1912) ، إذ أنه لم يوقعها باسمه المعروف وهو إذ ذاك محام ، له مكانته المهنية و الاجتماعية المرموقة، و إنما وقعها برمز مستعار هو ” مصري فلاح ” أو ” فلاح مصري ” و هو و إن كان يؤشر كما يرى ذلك بعض الدارسين على تخوفه على مكانته من أن تمس ، فهو من جهة أخرى ، يشير إلى انتمائه الفكري وطنياً و اجتماعياً إلى صف المستضعفين في الأرض و في مجتمعه بالذات .
ويؤكد بالتالي، الدكتور ربيع ، أن مثل هذه المناقشات و القضايا ، و إن كانت غير جوهرية و لا تعني المؤلف في شئ ، إلا أنها تفرض نفسها من الناحية المنهجية ما دام التعبير عنها وارداً و واضحاً؛ بل إنها قد تتعدى ذلك إلى طرح أكثر جدية مما تقدم ، و هو ما يرتبط بعلاقة الرواية و الأدب عامة بالواقع و بالتاريخ ، و هي أسئلة جوهرية أو لا تخلو من أهمية على الأقل ، و بخاص أنها تثار حالياً ببعض إلحاح أمام تنامي ظاهرة السرد الروائي المرتبط بالتاريخ ، سواء من حيث الشكل ، أو من حيث الأحداث ؛ و سواء على مستوى الاستلهام أو المحاكاة أو إعادة الكتابة ، حسب المقاصد و الاجتهادات .
و لعل المؤلف بكل بساطة ، إنما يريد أن يكون أميناً مع قارئه ، فهو يظهر له أنه إنما يقرأ أحداثاً تاريخية حقيقية ، لا دخل للخيال فيها ، و أن كل عمله ، إنما هو سوقها في هذا النحو المحبب المستحدث ؛ و هنا تكمن أهمية الطرح الذي ننطلق منه و نقدمه ، وهو ” السرد الروائي و الوعي الزمني ” لدى الأستاذ عبد الهادي بوطالب في هذه العمل ، و خاصة أن مشروعه الأدبي كان يتوجه إلى كتابة أعمال أخرى ، على المنحى نفسه ، حول شخصيات مماثلة في أهميتها و تجاربها لشخصية لسان الدين بن الخطيب ، من قبيل ابن خلدون و أمثاله .
و بغض النظر عن نوايا المؤلف و اجتهادات المحلل ، فإن ” وزير غرناطة ” يمثل سرداً روائياً ، ينساق فيه الحكي بمجمله على نحو خطي linéaire أي أنه يتبع السيرورة التعاقبية للتاريخ ، بالمعنى الذي يجعل علاقة بين التقدم في الحكي ، و تتابع الأحداث (4) ؛ إلا أنه لا يمثل خالصاً على النحو الخطي المذكور ، بل ثم في الشخصيات ومواقع السرد ، ما يخالط ذلك من قبيل شخصية ” عجوز غرناطة ” التي تحكي الأحداث للصغار ، و التي سرعان ما ينقطع أثرها في الحكي و الحدث ، بالمعنى الذي يشعر بالدخول في الحدث المباشر ذاته دون واسطة ، إلى أن تتم العودة إليها في النهاية ، و كأنها تذكير بمصدر السرد الأول أو بمثابة الاستفاقة من غفوة التماهي مع الحدث .
ويستخلص الدكتور ربيع بذلك أن هذه التقنية في العرض على بساطتها و طابعها العفوي ، ذات بعد بيداغوجي مزدوج أو متعدد ( إذا أدرجنا في الاعتبار موقع المؤلف الضمني و وجهة خطابه ) ، إذ لا يخفى أن السرد من الناحية الفنية ، يلقى على صبية و أحداث فيما بعد العصر إلى قبيل المغرب ، و هم جيل جديد متطلع لم يعش الأحداث ، و يحيون في عصر من عصور غرناطة مغاير لعصرالأحداث ، يلتفون في لهفة و شوق للسماع ، مبهورين من سحر ما يقوله السارد ، وسعة خبرته و اطلاعه ، و من غربة حياته المنعزلة في غور من مرتفع خارج غرناطة ، بلا أي أنيس ، متعاطفين معه و مع موضوعات حكيه ، و مطالبين إلى ما تشوقهم إليه العجوز بإيحاءاتها و عباراتها ، من أن لها من الأخبار ما يفوق سحر الحكي عن عنترة أو أبي زيد و غيره ، أخبار عن ماضي آبائهم و أجدادهن القريب ، و أن السارد و هو المرأة العجوز المنعزلة عن عالم غرناطة ( زمن الحكي لا زمن الحدث) تستشعر و تشعر برسالتها في تبليغ ما يجب إلى الأجيال ، لا تبغي من وراء ذلك شيئاً ، مفعمة بالعطف على الصغار الملتفين الشغوفين المتسائلين ، فتنبهم إلى ضرورة التوقف ، خوفاً عليهم من خطر الطريق في الظلام ، وما قد يتعرضون له من زجر ذويهم في حال تأخرهم ، و مما قد يعرضون إليه ذويهم من عنت ، بسبب تأخر الصغار في عودتهم .
ليس من المفيد التأكد مما إذا كانت العجوز شخصية واقعية أم لا ، و إن كا ن الأقرب التأكيد بدون أدنى حس من المغامرة أنها ليست كذلك ؛ إنما الأهم هو الوجود الروائي لهذه الشخصية في تقمصها لدور السارد الذي ليس من الضروري أن يكون عنصراً في الحدث أو المحكي . (5)
و إذ لا داعي لتأكيد الطابع الروائي للسردية الأدبية في ” وزير غرناطة ” من مجرد هذه التقنية بالذات ، فإن وعي الزمنية يفرض نفسه مبدئياً ، و على نحو تلقائي من هذا المفتتح ذاته ، و عبر شخصية العجوز الساردة فهي تحكي عن زمن لزمن بوعي كامل بالتحول الذي تم ، و الذي يمكن أن يتم ، بل إن استشعار الموقف بهذا الوعي الزمني متضمن في كل ذرة من فضاء السرد ، و من تشكل صورة العجوز ذاتها ؛ وهو ما لا تقدمه اللغة و العبارة فحسب ، بل يستشف من كثير مما هو غير ذلك ، من خارج العبارة ذاتها ، من فضائها أو شعاعها و إشعاعها و ما بين سطورها وفراغاتها (6) ؛ فالساردة العجوز لا تحكي لاستمتاع ذاتي بما تحكي في صيغته وعمقه الدرامي و لا لمجرد العبرة بما مضى ، و بالتأكيد لا للترفيه رغم طابع حب الاطلاع لدى المستمعين الصغار ؛ و إنما للحث و التحريض على صورة زمن مخالف أو معكوس أي إيجابي يمكن صنعه بما يرد الاعتبار للزمن الماضي أو للذات التاريخية الجريحة على الأصح. و في توجه هذه الشخصية التي تبدو بقدر ماهي عابرة أو هامشية ، بقدر ماهي منيرة لسبيل الحكي و الحدث على السواء ؛ يبرز عنصر التطلع لوجه زمن غير الزمن ، فهي تتحدث عما يمني به ملوك بني الأحمر أنفسهم و يمنون الناس به ، دون أن يعدوا أو يستعدوا جدياً لذلك ، و إنما ينصرفون على لهو حياتهم المعتادة ، و تطاحنهم من أجل السلطة و الملك ؛ فتنظر بعين المحاكم للحاضر و المتنبئ بالمستقبل على أمد قريب على الأقل ، فترى أن سبع سنوات مضت من ولاية أبي الحجاج ، وقد آلى على نفسه أن يحقق النصر و المجد دون جدوى ، بل أصبح ألعوبة في يد حاجبه ، وتتوقع العجوز أن تتلو ذلك سبع أخر شداد ، دون أية نتيجة (7)
و يفرض هذا الوعي عدم الاطمئنان كل الاطمئنان إلى أن صنع الزمن المنشود ممكن بسهولة أو صعوبة ، فالظروف المحيطة بزمن السرد ، قد تؤكد ذلك على وجه الاستحالة المطلقة إلى حد كبير ؛ إلا أن ذلك لا يتنافى مع متكإ الأمل و الحلم ، عن طريق إحياء الصورة في أذهان الأجيال الناشئة ، و هو ما يعني تضمين القصد باتجاه خلق وعي جديد متجدد ، قد يكون هو الأمل في صنع الزمن المنشود .
” إن الوعي الزمني في التحافه بالنسيج السردي على هذا النحو ، لا يمنع من تجلياته على مستويات أخرى ، تتمثل في جوهر و عمق مواقف الشخصيات و سلوكها في مواجهة (قدرها ) المأساوي إلى أقصى الحدود و أقساها ؛ و الواقع أننا إذا كنا بالنسبة لجنس الرواية عامة ” نستطيع أن نقول إن كل ما في الرواية من تتابع الأحداث ، ليس في أعمق محتوياته ، سوى معركة ضد قوى الزمن ” (8)، فإننا نستطيع أن نقول ذلك بالأولى بصدد رواية ” وزير غرناطة ” للأستاذ عبد الهادي بوطالب ، وذلك لقوة هذا الصراع و مأساويته ، و لعمق التيارات الحدثية ، و تعدد مجاريها ومجرياتها في نطاقه” .
و في هذا التوجه لالتقاط أقوى و أقسى اللحظات درامية ،يضيف الدكتور مبارك ، تمثل مشاهد من استبداد النساء و غلمان القصور بأرباب السلطة من الملوك و الحاشية (9) ؛ و تقلبات النفس البشرية التي لا ترتوي رغبتها في السلطة و لا تقف مطامحها حد ، و لا تفلها في ذلك محنة و لا تحول بينها عقبة (10) ؛ و يبلغ الحث الدرامي أوجه في مدراج من مشاهد محنة ابن الخطيب ، و هو يطرد من الأندلس – كما سيطرد منها من بعده – و كأنه آدم يطرد من الجنة ؛ و بعدها في وقوفه بأغمات على قبر المعتمد بن عباد يناجيه روحاً و شعراً ، وكأنه يستشعر المصير المشابه قبيل حلوله (11) ، ثم بعد حلول المحنة و هو يختبر في سجنه أسرار القبور ، بعد أسرار القصور ، في عزلة مظلمة و صمت مقيم ، لا يتبين في ذلك إلا صلصلة أصفاده عند كل حركة أو سكون منه (12)؛ ليبلغ الأمر ذروة اللامعقول في حوار مع السجان الذي يمعن في إذلال الوزير الأديب ، معتزاً بمهمته و بمؤسسته التي تؤوي بين الحين والآخر بعض ذوي الشأن الأكبر ، من أمثال لسان الدين بن الخطيب ؛ و يمثل أوج سخرية الأقدار ، في أن يعود هذا السجان نفسه يفتح الأبواب عن سجينه ، و في هذه المرة يترجاه ليذكره عند صاحبه ، فهو لم يقم بغير الواجب ، ليعود السجين مرة أخرى أكثر انكساراً وأشد محنة إلى سجنه و سجانه ، حيث تكون نهايته خنقاً على أيدي الدهماء (13).
ويؤكد هنا الدكتور مبارك ربيع أن ما تتميز به ” و زير غرناطة ” من فنية التركيز على قوة الفعل الزمني ، في اختيار مواقع الصراع و مقابلة أكثر لحظاتها درامية ، لهو مما يؤكد سرديتها الروائية و قوي حمولة الوعي الزمني في إطار ذلك .
كما لا يمكن بطبيعة الحال استنتاج أي غيبة للمؤلف بمجرد السرد على لسان الغائب ، او التوسل التقني البيداغوجي بشخصيات السارد العجوز ، و لو باعتبار أن كلا من العجوز و ضمير الغائب ، مفوضان في وعيهما الزمني ، من وعي المؤلف ذاته في الاتجاه نفسه ؛ و غنما المؤلف حاضر بالشروط الموضوعية التاريخية الجغرافية والحضارية الثقافية المحيطة بكتابة النص ذاتها ، و التي أشرنا إلى جماتها سابقاًّ .
و إن نقل مضمون عصر بمعجمه و أحداثه ، إلى عصر آخر له أدواته الخاصة به في التعبير و التفاعل ، بأسلوبية نوعية في السرد ، لهو الزمنية ذاتها ؛ و إذا كان ماحاولنا تبينه من تجليات و أبعاد الوعي الزمني لدى الساردة العجوز ، ليس إلا استعارة من المؤلف ، فإن اختيار الشخصية الرئيسية في الحدث و هي الوزير الأديب لسان الدين بن الخطيب هو بذاته يشكل هذه الزمنية في أقوى صورها ، ويمثل عمق الوعي الزمني لدى الكاتب في أعلى مظاهره .
ويقول الدكتور ربيع أنه بالاستناد إلى معرفته بالأستاذ عبد الهادي بوطالب ليس بسر من مسارات حياته العلمية و الثقافية و السياسية و الأدبية ، على مدى أكثر من نصف قرن، أنه” لو كتب هذه الرواية في أواسط أو أواخر زخم هذه المسارات المكثفة ، وبخاصة في خضم حياته السياسية بما فيها من غنى و ثراء ، و بما عرفته من تحولات و تقلبات ، أو بما لم تخل منه يوماً على مدى نصف قرن ، مما يسميه هو نفسه ” دسائس القصور ” (14) و ما في معناها ؛ لو تم ذلك على هذا النحو ، لأمكن بكل يسر إدماج روايته ضمن مفهوم من ” إسقاط ” الخبرة على الشئ ، و ذلك على مستوى اختيار الموضوع قبل كل شئ ، و هو ما كان كفيلا بان يجعلنا نتحدث عن وعي زمني ( بعْدي) لدى الكاتب ، يتمثل في سرد و تحليل روائي ، لمرحلة تاريخية شكلت عالم وزير غرناطة لسان الدين بن الخطيب وعصره ، و هو ما يشكل و يقدم بالتالي ، صورة لمجتمع دسائس القصور وتقلبات الأيام و الدهور ، بكل حق ومأساوية ؛ أما و كتابة الرواية جاءت مبكرة في الحياة الفكرية الأدبية للأستاذ بوطالب ، فلا عسف و لا عنت في التنبيه و التنبه على الأقل إلى السمة القبْـلية لهذا الوعي الزمني لدى الكاتب، و بدل الحديث عن ” إسقاط ” بعْدي للخبرة الشخصية على التاريخي و الروائي ، يمكن الإشارة إلى نوع من الاستيعاب القبْـلي ، أقرب وأشبه ما يكون بعملية ” تقمص” فكرية ، لعصر و مجتمع بأحداثه و شخصياته وعلاقاته ؛ و عي زمني يؤشر على الوجود المتصل الأصيل للزمنية خارج حدود الدلالات و الفواصل الاضطرارية أو الوهمية إلى حاضر و مستقبل و ماض ، وإنما بالحضور الزمني الكلي ، في أي من جزيئات و فواصل الوجود الزمنية” .
و هكذا يسرسل الدكتور ربيع سابرا أغوار رواية الشيخ بوطالب “وزير غرناطة ” ليستنتج أن
روائية الماضي و تاريخيته أصبحت هي روائية الحاضر و تاريخيته ، كما هي روائية المستقبل و تاريخيته ؛ و لا يتضمن ذلك مجرد التكرار و التشابه بغرض التسلية و الترويح أو العبر و الاعتبار ، إنما بهدف ما يتضمنه حكي ” عجوز غرناطة” ، من تطلع لصنع التاريخ ، الزمن ، المستقبل ؛ و إن ما يأتي على لسان فيلسوف التاريخ و هو المعاصر لمرحلة هامة من أحداث الرواية و شخصية ذات أهمية ضمن شخصياتها و مجتمعها ، من قبيل ” عودتنا الأيام أن تسرف في الظلم والطغيان كلما امتدت بها العظمة ؛ و الظلم مخرب العمران (15) ” إنما يؤول على ضوء ما نحن بصدده من الوعي الزمني ، إلى أن ذلك القدر المقدور إنما هو ذو وجهين أو وجوه ، و إنما يحل بجهد ؛ و لا بد من إدارة المنشود منها بجهة ناشده ولصالح العامل بقصد للوصول إليه ؛ و هو ما يؤكده الوعي الزمني في هذا السرد الروائي الدرامي في تساؤل يبدو غنياً عن كل جواب ” و هل التاريخ إلا سلسلة أحداث لا تمضي إلا لتعود، و لا تنسخ أية إلا أتت آية مثلها ؟ ” (16) ؛ إذ يتسع الجواب في هذا السياق المتسائل ، لفرجة أمل و فسحة عمل ، من أجل أن تكون دورة الأيام و الأحداث ، باتجاه سابق عهدها المفقود المنشود ، مهما كانت التضحيات والجهود .
فرضيتنا نؤكدها مرة أخرى ، و إن كانت تبدو في غير حاجة إلى ذلك ، و هي أن الكاتب لا ينطلق من فراغ ، و إنما من مجتمع و واقع له ظروفه الراهنة ( إذ ذاك ) ، إلى تاريخ و واقع كانت ظروفه أيضاً ، بوعي الشبيه و الفارق ، إذ ” الشعوب منذ كانت لا تدوم لها حال ، و لا تستقر لها عواطف ، و إنما هي في تقلب لا ينتهي : شأن الأطفال ينسون ما ألفوه من قبل ، و يحبون اليوم ما كرهوه و انصرفوا عنه بالأمس ” (17) ؛ و كل ذلك بقصد صنع التحول الزمني المجتمعي المنشود ، النسخة المغايرة للواقع الحالي ( إذ ذاك ) ، سواء منه حاضر الكاتب ، أو قبله حاضر الأحداث نفسها ، و حاضر عجوز غرناطة .
“لا ننسى هنا أن السارد الأولي و الأساسي الذي تمثله ” عجوز غرناطة ” و إن كان لا يلبث أن يسلم قيادة السرد لضمير الغائب ، أو للمؤلف الذي يستعيدها على الأصح، بكامل سلاسة غير منظورة و لا محسوسة ، يجعل استشعار صوت العجوز مستمر ضمنياً حين تواريها ، كما كان و يضل استشعار ضمير الغائب أو المؤلف ضمنياً حين حضورها ، ما يؤشر على تماه بين الصوتين و تكامل بين الزمنين أو الوعيين الزمنين على الأصح “.
ويبرز، الدكتورمبارك ، في هذا المفصل من الفارق و الشبيه ، ما ببن زمن و آخر و وعي و آخر ، أنه يمكن إلقاء بعض الضوء مرة أخرى ، على توهم إشكال خاص من منظور الواقعي والروائي، كما هو من منظور التاريخي و الروائي كذلك ؛ و ذلك باعتبار أن التناقض ليس بالضرورة بين وهم و واقع ، كما قد يبدو لأول و هلة ؛ بقدر ما هو بين مفاهيم مختلفة أو متناقضة ، للواقع و الوهم على السواء .
ويضيف أن الشبيه و الفارق ليفرض نفسه في كثير من سمات و مسارت كل من لسان الدين بن الخطيب الشخصية ( الروائية التاريخية ) من جهة ؛ و عبد الهادي بوطالب ( المؤلف و السارد الحاضر الغائب )، لا يقف عند حدود الملمح السياسي المشترك ، و إنما في الملمح الجوهري للشخصية ، و هو الملمح العلمي الأدبي الثقافي ، حيث إن غرام ابن الخطيب بل و لعه بالكتاب و التأليف هو المحرك لكل فاعلياته ، و هو ما تعمل باستمرار على أن ” تصرفه عنها السياسة ” (18) و هو من أجل ذلك يغتنم الفرصة تلو الأخرى ، للتفرغ بفكره إلى قلمه و كتابه ؛ و هو من جهة أخرى ما عانى منه الأستاذ بوطالب و خبره ( طيلة عقود بعد كتابة الرواية )، لينتهي في أوج عطائه السياسي و الفكري إلى طلاق السياسة ، و التفرغ للكتابة و الإنتاج الفكري .
لا بد من احتراز كبير، يؤكد الدكتور ربيع، في مقاربة الشبيه و الفارق هذه ، بيد أن من الضروري الإقرار بقوة ذلك ، في الشخصيتين معاً ، و هو من منظور الوعي الزمني و فرضيته، يضفي بعداً هاماً ، يمثل بوجهين مختلفين في كل من الشخصيتين اختلاف الشبيه المفارق في آن :
“يتمثل أولهما ، في أن مظاهر و ظواهر إغراء السياسة ، إذ تصل بابن الخطيب إلى المعاودة و الإقبال ، كلما راودته بانقيادها بعد صدود ؛ بل و يتعمق فيه جدل السلطة و الخضوع ، إلى حد انتشاله من غيبوبة تجربة تصوف روحية عميقة في سلا ، على نحو ما تتميز به الصوفية المغربية في طابعها : عزلة وانعزال عن المجتمع ، و من التيه أو السياحة والرحلة في الفيافي و الجبال بمختلف مناطق المغرب ، و في سبيل المقاصد التصوفية من لقيا الأولياء والصالحين ( 19) ، كما في مراكش و سائر المراكز والمدافن الروحية الدينية ؛ ليستجيب لنداء السياسة من جديد ، و يعود لتبوإ مواقع العز و المجد من جديد ؛ ثم لترمي به من جديد ، جدلية الدورة السياسية تلك إلى الحضيض ، و إلى أكثر من الحضيض ، إلى النهاية المأساوية المبتئسة ليقضي في السجن على أيدي خانقيه من الدهماء الذين أوغرت صدورهم ، و أوقظت نيران غيظهم ، بل وُجّهوا توجيهاً إلى الفتك به ، انطلاقاً من تآويل مغرضة لبنات الفكر الخطيبية ، و روائع يراعه من نثر و شعر .
و بينما يتمثل ثانيهما في الجدلية نفسها على نحو مختلف في شخصية المؤلف ، إذ بعد كل الممارسات في الجدلية المعهودة للسلطة و الأمجاد السياسية ، و بعد ” نصف قرن في الساسة ” ينتصر المفكر الأديب عبد الهادي بوطالب لنتاجه الفكري ، معرضاً كل الإعراض عن إغراء السياسة و أمجادها ، إلى عالم الفكر و التأليف “.
اذن فمقارنة الشبيه و المفارق هذه ، بقدر ما تفرض نفسها ، بقدر ما نخرج منها رغم كل جهود الاحتراز بأنها ثمرة الوعي الزمني ، الوعي الحاد بالتحول على كافة مستوياته، بما فيه من أبعاد التقلبات المأساوية المحتملة الواردة في كل ظرف ؛ و هو وعي لا يأتي عن خذلان و تخاذل ، بقدر ما ينجم عن إشباع و اقتناع ، بأن النصر في نهاية هذا الجدل المعهود ، يمكن أن يسجل على نحو مخالف و نادر ، بل إنه نصر يجب أن يصنع بحروف الإرادة الواعية ، و يكتب في النهاية للفكر بصفة قطعية حاسمة .
و يؤكد، الدكتورمبارك، أن بالإجمال ، أنه إذا كان صحيحاً أن ” العمل الأدبي حتمي يفرض على القارئ مقوماته ” (20) ، و ذلك يقدر ما يكتشفه القارئ ، لا من خلال اللغة وحدها وغير اللغة من مكونات الكتابة من قبيل الصمت ذاته و مناقشة العبارات (21) ، فإن ذلك يصدق بما هو أحق و أجدر على ” وزير غرناطة ” ، و هو ما يشكل قوة فرضيته (أي فرصية الدكتورمبارك)
عن ” الوعي الزمني ” في هذا الرواية ، و يقود إلى ما يقود إليه على نحو عرضي أو جوهري من مناقشات على غرار مقارنة الشبيه و المفارق ؛ التي تمثل و كأن المؤلف يكتب روايته بعدياً ، أي إلحاقاً بخبرة يومية حية ومعاناة واقعية ؛ و الحال أنه يكتبها قبلياً ، ليمارس و يخوض بصفة عملية ، وضمن شروط وجود محددة اجتماعياً و بشرياً ، غمار تجربة غنية و طويلة ، سياسية تقافية أدبية حافلة ، تشكل رافداً لكل المشابهات و المفارقات ، محتفظة في الآن نفسه بطابعها الشخصي ، و ميسمها المتفرد .
و” إذا كانت رواية ” وزير غرناطة ” للأستاذ عبد الهادي بوطالب ، من طرحنا السابق و غيره ، كفيلة بأن تثير كافة أدبيات القضايا المتعلقة بالأدب الروائي ، وبالرواية التاريخية على الخصوص ، فيما هو محيطي من ظروف عامة و خاصة ، و ما هو بنيوي يكمن في التركيب الروائي ذاته ، كما في العلاقة مع ذات الكاتب نفسه؛ فما ذلك إلا دليل على غنى وخصوبة في العمل الأدبي و في التجربة على السواء. واختتم صاحب رواية «بدر زمانه» مداخلته في جو مفعم بالسكون والانتباه والتركيز سوى من دقات قلوب محبي المحتفى به، مؤكدا أن هذا العمل الأدبي الروائي الباكر في حياتنا الفكرية ، يمثل معلماً مضيئاً في مسار الأدب المغربي المعاصر ، و ثمرة يانعة أولى ، من نماذجه الروائية” .
ــــــــــــــــــــــــــ
هوامش أحال اليها الدكتور مبارك في بحثه السرد الروائي و الوعي الزماني في رواية ” وزير غرناطة” :
1ـمحمد سعيد العريان ، مقدمة رواية ” وزير غرناطة “
2 ـ انظر بعض تفاصيل الموضوع مثلا في : رسائل علال الفاسي ، رسالته إلى طه حسين (وزير المعارف بمصر إذ ذاك ) ، جريدة العلم ، ص 3 العدد 20476 / 20 يوليوز 2006
3 ـ جورج لوكاش ، نظرية الرواية ، ص 115 ، ترجمة الحسين سحبان ، منشورات التل ، الرباط 1988
4- Georges Molinié , La stylistique ,P. 30-31, PUF , Paris 1993
5 ـ نفسه
6 ـ جان بول سارتر، ما الأدب ؟ ص 43 ،مكتبة الأنجلو المصرية ، القاهرة 1971
7 ـ عبد الهادي بوطالب ، وزير غرناطة، ص31، ط 7 دارالكتاب ،البيضاء2004
8 ـ ج . لوكاش ، ص 117
9 ـ وزير غرناطة ، 122
10 ـ ” ” ” 165 ، 194
11 ـ ” ” ” 158
12 ـ ” ” ” 221
13ـ ” ” ” 224 ، 229
14 ـ عبد الهادي بوطالب ، نصف قرن في السياسة ، ص 335 ــ 341 ، منشورات الزمن ، 2001
15 ـ وزير غرناطة ، ص 160
16 ـ ” ” ” 140
17 ـ ” ” ” 95
18 ـ ” ” ” 71
– 19 ــ Omama AOUAD-LAHRACH , LA VILLE ET LECITADIN DANS LE ROMAN HISPANO-AMERICAIN ACTUEL ,in Langues et litteratures P 201 , publications de la faculté des lettres et des sciences humaines – Rabat , volume viii 1989 – 1990
20 ـ سارتر ، ص 43
21 ـ نفسه