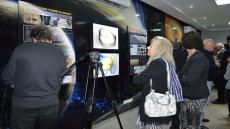حين يرحل رجال الروح.. ويتركوك في العراء
مكناس: محمد التفراوتي
منذ أن توفي جدي، سيدي محمد بن هاشم، وغيابه خلف في داخلي فراغا روحيا عميقا.
كان جدي بالنسبة لي أكثر من ذاكرة أسرية، كان مرآتي إلى عالم نقي، وأرضا أقف عليها بثقة. برحيله، شعرت أنني أفقد الجذر، وأتيه في زمن لا يشبهني.
لجأت إلى أصدقائه، وجوههم كانت تهمس ببعض ملامحه، بظله، بنبرته.
كنت أتمعن في قسماتهم، أبحث فيها عن بقايا ذلك النبل الذي رحل.
أشخاص مثل مولاي هاشم البلغيتي، والحاج عبد المحسن، لم يكونوا مجرد رجال كبار في السن، بل كانوا امتدادا حيا لهيبة جدي، يرممون هشاشتي، ويخففون من ثقل الغياب.
كلما فقدت أحدهم، كان الحزن يتضاعف.
وكلما دخلت مدينة مكناس، كنت أرى جدي يبتسم من بين الزوايا، في وجه مولاي هاشم، في نبرة الحاج عبد المحسن، في سكينة المجالس وروح التلاوة.
لكنهم رحلوا… تباعا، بهدوء، وكأنهم يدركون أنهم يؤدون رسالتهم الأخيرة.
صرت يتيما من نوع آخر.
لا زلت أشتاق، وأحلم به في المنام، في بيوت مختلفة، كأن الذاكرة تبحث عن مخرج للحزن عبر بوابات الحلم.
مرت سنوات، وقلبي يحدثني أن الرفاق انتهوا، حتى التقيت برجل من معدن جدي ذاته:
الحاج عبد الله بورشاشن، والد أحد أصدقائي.
كان رجلا مهابا، بصوته الجهوري وهو يقرأ الحزب الراتب في الجامع الكبير، بنظراته الثاقبة التي تعيد للتلاوة المغربية وقارها، وبهيبته التربوية التي تشبه المعلمين الكبار زمن الخشوع والتلقين الصادق.
لم يكن مجرد حافظ لكتاب الله، بل كان من الذين يشعرونك أن التربية مهمة مقدسة.
كانت ملامحه تحمل وقارا قديما، ممزوجا بنفس معاصر.
رجل يتحدث بلغة أهل الحكمة، لكن بلطف الكبار، بلا استعلاء.
كان إذا حدثك عن التعليم، تفهم أنه علم أجيالا لا تعد، وكان حريصا على اللغة، على القيم، على ضبط النفس، على قوة الشخصية مع طيب القلب.
تحدث عن المدرسة كمن يتحدث عن بيته الأول، وعن التلاميذ كمن يتحدث عن أولاده.
ولم تكن هذه العبارات مجازا، بل حقيقة يشهد لها كل من تلقى على يده العلم أو رافقه في مدرجات المعرفة.
لم تكن شهادات الناس عنه مجرد مجاملة، بل كانت اعترافا صادقا من أجيال مرت من تحت يده.
كثير من تلامذته كانوا يروون مواقفه الصارمة حينا، والحنونة حينا آخر، وكيف كان يصر على أن يبدأ كل درس بآية، ويختمه بدعاء.
كان يربي قبل أن يعلم، يقوم السلوك بنظرة، ويوجه الفكر بجملة قصيرة لكنها راسخة.
أحدهم قال لي:
“علمني الحاج عبد الله أن أكتب حرف الألف باستقامة، وقال لي: لا تكن أعوجا في حياتك كما يكتب الألف المنكسر.”
وآخر قال:
“كنت أتهرب من المدرسة، لكنه لحق بي في الزقاق ذات صباح، لم يصرخ، فقط وضع يده على كتفي وقال: غدا ستشكرني، فلا تخذلني اليوم.”
لم يكن درسه ينتهي عند سبورة وطباشير، بل يمتد إلى أخلاق الناس، إلى بيوتهم، إلى طريقة حديثهم وسلوكهم في الشارع.
لهذا حين يذكره أهل مكناس، يذكرونه لا كمدرس فقط، بل كـ”مربي مدينة”.
اقتربت منه، وتوطدت العلاقة.
كنت أزوره في بيته، ذاك البيت الذي تحول إلى ملتقى روحي لزوار يبحثون عن الدفء القديم.
معه، عادت لي الحياة:
جلسات الذكر، والنقاش، والضحك البريء، والمقارنة بين زمن مضى وزمن حاضر، وقيام الليل، وتلاوة لا تنقطع.
كأنه آخر رجل يحمل ملامح الجيل الذي عشقت.
لكن الرحيل لا يرحم، وجاء دوره.
فرحلت معه قطعة جديدة من ذاتي.
تكرر المشهد… تكرر الألم.
منذ طفولتي وأنا أبحث عن رجال يشبهون جدي…
رجال لا تصنعهم الخطابات، ولا تفرزهم الصدفة، بل تنبتهم المحبة، وتطهرهم الحياة الصادقة.
واليوم، قل من يشبههم.
ورغم أن حولي أصدقاء طيبين، وأحباء مخلصين، يبقون سندا في هذه الحياة، إلا أن لتلك الأرواح الراحلة مقاما خاصا في قلبي لا يملؤه أحد. هم ليسوا أفضل من غيرهم بالضرورة، لكنهم كانوا امتدادا لروح تربيت في حضنها، وتشبعت منها بالمعنى.
فالمعذرة لأحبتي اليوم… إن لم أشف من الحنين، فبعض الأشخاص لا ينسون، بل يرافقونك كضوء خافت في الطريق، تشتاق إليه كلما أظلمت الدنيا.